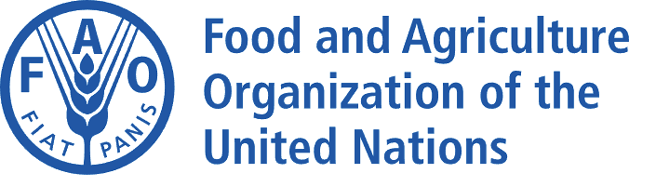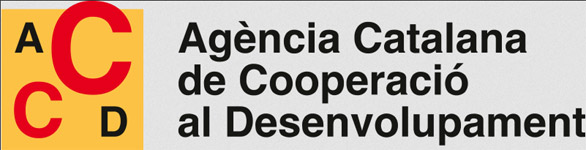يتصاعد الجدل حول تعديل قانون ”الإيجار القديم“ في مصر، حيث تصطدم حقوق ملايين المستأجرين المهددين بالتشريد مع مطالب مُلاك العقارات بالعدالة الاقتصادية.
في الشهور الأخيرة، بدأت سحر* – لأول مرة في حياتها – متابعة أخبار البرلمان المصري، حيث يناقش النواب قانونًا قد يؤدي إلى فقدانها المنزل الذي عاشت فيه منذ نحو أربعين عامًا.
تسكن سحر، ذات السبعين ربيعًا، مع ابنتها الوحيدة في شقة مؤجرة بحي ”الدقي“ بمحافظة الجيزة. ورثت سحر عقد إيجار الشقة عن زوجها، الذي بدوره كان قد ورثه عن والده. قيمة إيجار الشقة، الواقعة في شارع هادئ مليء بالأشجار، تبلغ نحو 1500 جنيه (30 دولار) سنويًا. تخضع الشقة لنظام قانوني جرى تسميته ”الإيجار القديم“، وهو ما سمح لسحر بأن ترث عقد الإيجار، وأن تبقي على قيمته المنخفضة.
وبينما يقترب مجلس النواب من تمرير قانون جديد قد يُنهي هذا النظام، ويحرر العلاقة بين ملاك العقارات ونحو 1.6 مليون أسرة من المستأجرين، تجد سحر نفسها في وضع صعب. فهي تعيش على معاش حكومي يكفي بالكاد مصاريفها الشخصية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تأجير شقة أخرى في نفس المنطقة بأسعار السوق التي تبدأ من حوالي 15 ألف جنيه (حوالي 300 دولار) شهريًا، ناهيك عن شراء شقة أخرى في نفس المنطقة حيث تبدأ أسعار الشقق الملائمة من حوالي 2 مليون جنيه (40 ألف دولار) على الأقل.
”لا أريد البهدلة آخر أيام حياتي“، هكذا وصفت سحر شعورها في مقابلة مع معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. ”البهدلة“ – بمعنى التعب المصحوب بالإذلال والمعاملة السيئة – هو ما يؤرق ملايين المصريين الذين قد يجدون أنفسهم مطرودين من مساكنهم حال إلغاء الإيجار القديم.
من الناحية الأخرى، يشعر أصحاب البناية التي تقطنها سحر، وهم أيضًا ورثة المالك الأصلي، بالظلم، حيث إنهم يمتلكون أصل تقدر قيمته بأكثر من 30 مليون جنيه (نحو 600 ألف دولار) لكنه لا يدر لهم أي عائد يذكر.
”نحن أصحاب أملاك على الورق فقط. لكن في الواقع، نحن فقراء!“، هكذا وصفت أُلفت، التي تمتلك العقار مع 5 من أخواتها، واقعها.
وبالرغم من أن الجدل حول قانون الإيجار القديم مستمر منذ عقود، إلا أن المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر 2024 بعدم دستورية المواد القانونية الخاصة بثبات القيمة الإيجارية، ما أعاد المسألة إلى صدارة النقاش العام في مصر. كما ألزمت المحكمة الحكومة بتعديل نظام الإيجارات القديمة قبل نهاية يونيو 2025، وإلا ستتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر تلقائيًا.
تخلق مسألة تعديل نظام الإيجارات القديمة معضلة، حيث إنه قد يؤدي إلى تبعات اجتماعية خطيرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع لمعدلات الفقر، لكنه في الوقت نفسه قد يُنعش السوق العقاري، ويحرر أصول تستطيع الدولة استغلالها لتساعد على سد عجز موازنة مزمن.
كما يتخوف البعض من أن يفتح تعديل النظام الطريق أمام أجهزة الدولة للسيطرة على بعض أحياء القاهرة الكبرى والإسكندرية بهدف طرحها أمام المستثمرين، بدون النظر إلى المصالح الاقتصادية والاجتماعية لسكان تلك الأحياء.
حروب وهزائم
نشأ نظام الإيجار القديم في بدايات القرن العشرين في مصر كإطار قانوني استثنائي لحماية المستأجرين وضمان استقرارهم السكني. بدأت التدخلات التشريعية في العلاقة الإيجارية بعد الحرب العالمية الأولى بصدور قانون رقم 11 لسنة 1920 الذي فرض حدًا أقصى للإيجار، تلاه القانون رقم 121 لسنة 1947 كأول تشريع شامل للإيجارات، والذي فرض قيودًا على الإخلاء وحدد حدًا أقصى أيضًا، مع السماح باسترداد الوحدة للمالك أو أقاربه بشروط محددة.
ثم جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 في سياق سياسي واجتماعي شديد الحساسية، عقب هزيمة 1967 وما خلفتها من اضطرابات اقتصادية واجتماعية، وفي ظل أزمة إسكان متفاقمة وارتفاع الكثافة السكانية في المدن المصرية الكبرى. اتجهت الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل. فكان القانون جزءًا من سياسة اشتراكية تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي من خلال تثبيت الإيجارات، وامتداد عقود الإيجار لتشمل أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة (الأبناء، والإخوة، والأعمام، والعمات، والأحفاد).
ولم يتحقق قدر من التوازن في العلاقة الإيجارية إلا مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أعاد تنظيم العلاقة، مانحًا أصحاب العقارات حرية أكبر في التعاقد، مثل تحديد مدة العقد، وإمكانية زيادة الإيجار، بما يتناسب مع ظروف السوق. ولم يطبق قانون 1996، أو ”قانون الإيجار الجديد“ كما جرى تسميته، بأثر رجعي على العقود الموقعة قبل صدوره، لتبقى خاضعة للقيود الواردة في القوانين التي سبقته.
نظام معقد
مر نظام الإيجارات القديم بالعديد من التطورات عبر تاريخه، ما يجعل محاولة الوصول إلى تشريع يحفظ حقوق المستأجرين والملاك معًا أمرًا شديد التعقيد. فمنذ نهاية الستينات، واستفحال الأزمة السكانية في المدن المصرية، بدأ بعض ملاك الوحدات السكنية في تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقدمًا، جرى تسميتها ”خلوّ رجل“، كشرط تأجير وحداتهم، ما يجعل العلاقة التأجيرية أقرب إلى قروض عقارية طويلة الأجل، يدفع المستأجر مقدمًا للوحدة، ثم يستمر في دفع ”أقساطها“ في شكل الإيجار المتفق عليه. وكان المستأجرون يدفعون تلك المبالغ على اعتبار استمرارية انتفاعهم وأسرهم بالوحدات السكنية لفترات طويلة.
على سبيل المثال، يستأجر أحمد المصري محلًا تجاريًا في مدينة الإسكندرية بقيمة 40 جنيه شهريًا (أقل من دولار واحد) بموجب عقد قديم كان محررًا بين والده ومالك العقار. في الوقت الحالي، القيمة السوقية العادلة لإيجار نفس المحل تصل إلى 6000 جنيه (نحو 120 دولار) شهريًا. يقول أحمد أن وقت تحرير العقد سنة 1992 دفع والده مبلغ 33 ألف جنيه ”خلو رِجل“ لصاحب العقار، وهو ما كان يعادل وقتها حوالي 10 آلاف دولار.
أما من ناحية مُلّاك العقارات، يشكّل النظام عبئًا اقتصاديًا عليهم، خاصة في ظل الفجوة الواسعة بين القيمة الإيجارية الثابتة منذ عقود وبين القيمة السوقية الحالية للعقارات.
وحيد الأحمد، أحد مُلاك العقارات الذين تحدثنا معهم، ورث مع أخوته بناية سكنية مكونة من 15 طابقًا بمنطقة الدويقة، أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة. يقول وحيد أن المستأجرين يدفعون 70 جنيهًا (أقل من دولار ونصف) سنويًا في المتوسط، في وقت يبلغ فيه الإيجار بالمنطقة 2500 جنيه شهريًا على الأقل. ورغم امتلاكه هذا العقار، يعيش وحيد في غرفة داخل شقة مشتركة بإيجار شهري قيمته 1500 جنيه. يحاول وحيد الآن بيع الشقق للمستأجرين القاطنين فيها، لكنهم يبخسون أسعارها لأنهم يعرفون أنهم في موضع قوة. على سبيل المثال، عرض أحد المستأجرين شراء الشقة التي يسكن فيها بمبلغ 70 ألف جنيه (1400 دولار)، في حين أن الشقة يبلغ سعرها السوقي نحو نصف مليون جنيه (10 آلاف دولار)، بحسب وحيد.
ومن أبرز الإشكاليات أيضًا مسألة انتقال العقد بالوراثة، حيث ينتقل الانتفاع بالوحدة السكنية من المستأجر إلى ورثته الذين كثيرًا ما يتركون الشقق مغلقة، مطمئنين إلى استحالة أن يستردها أصحاب البنايات.
في حالة وحيد، معظم المستأجرين في بنايته هم ورثة من وقعّوا على العقود الأصلية. إحدى تلك الشقق مغلقة منذ 5 سنوات، حيث إن الوريثة تسكن في منطقة أخرى، وترفض التنازل عن العقد. كما قام أحد المستأجرين بتأجير الشقة من الباطن بمبلغ 2500 جنيه شهريًا لشخص آخر، في حين أنه يدفع 70 جنيه سنويًا.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الملاك إلى التخريب المتعمّد لأساسات المباني، بهدف تسريع انهيارها وبيع الأراضي التي تقام عليها بأسعار مرتفعة. وتضمنت هذه الممارسات أفعالًا مثل الحفر في البنية الداخلية، أو استخدام مواد مثل ”الديكسبان“ التي تفتت الأسمنت بشكل تدريجي ودون إحداث ضوضاء، في مسعى لتقويض المباني دون إثارة الانتباه.
ضيق المدة الزمنية
جاء حكم المحكمة الدستورية ليحرك المياه بعد عقود من الركود. فقد ألزم البرلمان المصري بتعديل نظام الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي في يونيو 2025، مما أثار القلق حول إصدار قانون غير متوازن لا يراعي مصالح الأطراف المتأثرة نظرًا لضيق المهلة الزمنية. وفقًا للحكم، في حال صدور التشريع في الوقت المحدد، ستُنظم نسبة الزيادة في الإيجار حسب طبيعة المنطقة ونوع العقار، أما إذا تأخرت التشريعات فسيُتاح للملاك اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى طرد ضد المستأجرين.
واللافت أنه بينما ظل ملف الإيجار القديم معلقًا أمام المحكمة الدستورية لمدة 26 عامًا دون حسم، صدر الحكم الأخير بعد عام واحد فقط من توجيهات الرئيس المصري بضرورة إنهاء الملف، مما أدى إلى تحرك سريع من مجلس النواب لإعداد قانون جديد. يكشف هذا التسلسل الزمني عن واقع إدارة السياسات العامة في مصر، حيث تحظى توجيهات السلطة التنفيذية بالأولوية المطلقة على حساب الاستقلالية التشريعية والقضائية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب المصري يوم الأحد 4 مايو 2025 اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تضمن رفع القيمة الإيجارية وتطبيق زيادة سنوية، وإنهاء مدة الإيجار الخاضعة لهذه الأحكام بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، أي تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ورغم أن مجلس النواب المصري اعتاد تمرير مشروعات القوانين الحكومية دون اعتراض يُذكر، فإن مشروع قانون الإيجارات القديمة فجّر خلافًا استثنائيًا جمع الحليف والخصم تحت مظلة الرفض. إذ توافق نواب من الأغلبية والمعارضة على أن الصيغة المطروحة غير متزنة، مؤكدين افتقارها للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وغياب آليات حقيقية لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
تركّزت الاعتراضات على عدة محاور؛ أبرزها التشكيك في دقة البيانات الحكومية حول أعداد الوحدات المؤجرة والمقيمين بها، واعتبار توقيت طرح المشروع غير مناسب في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية أخرى أولى بالمعالجة. كما وُصفت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية بالمبالغ فيها، مع المطالبة بربط الزيادات بمعدلات التضخم ومستويات الأجور، بدلًا من فرض زيادات مطلقة. كذلك، أثار المشروع انتقادات بسبب إغفاله قضية الوحدات المغلقة التي تصل إلى 12 مليون وحدة سكنية، وغياب حوافز أو ضرائب تُعيدها إلى السوق العقارية، ما يفاقم أزمة نقص المعروض ويدفع نحو المزيد من الاحتقان الاجتماعي. وطالب النواب بمراجعة شاملة تضمن صياغة متوازنة تحقق استقرار سوق الإيجار، وتعيد الثقة بين المالك والمستأجر.
رغم هذا الرفض نادر الحدوث، تجاهلت الحكومة كافة الملاحظات والاعتراضات، لتعود في يونيو 2025 بمشروع قانون جديد لا يختلف جوهريًا عن سابقه. أبقى المشروع الجديد على فلسفة إنهاء عقود الإيجار القديم، وزيادة القيم الإيجارية بشكل مطلق، دون الاستجابة للمطالب البرلمانية والاجتماعية التي طُرحت في المرة الأولى.
ينص مشروع القانون المطروح حاليًا على تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، تُحرر بعدها العلاقة الإيجارية لتخضع للقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين. كما يرفع المشروع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه أو 20 دولار)، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه أو 8 دولار) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه أو 5 دولار)، ولغير السكنى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. ومنح المشروع المتضررين أولوية في تخصيص وحدات بديلة من الدولة مقابل إخلاء الوحدات الأصلية.
الإخلاء القسري، ومخاوف أخرى
أحد أبرز المخاوف، في حال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون وجود ضمانات اجتماعية، هو تعرّض آلاف الأسر لخطر الإخلاء القسري، ما يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي داخل الأحياء. يتفاقم هذا الخطر بسبب هيمنة شركات الاستثمار والمضاربين على السوق العقاري، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية التي تتربح من مشروعات الإسكان. وقد ساهم ذلك في الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات خلال العقد السابق.
كما يؤدي هذا الوضع إلى تآكل فرص السكن الملائم لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث أصبحت الأولوية لتحقيق أقصى عائد استثماري على حساب البُعد الاجتماعي، وهو ما يعمّق الفجوة الطبقية ويعيد رسم خرائط الأحياء والمدن وفقًا لاعتبارات الربح بدلاً من العدالة.
تزامن مع هذا الغلاء التوسع في قطاع الإسكان غير الرسمي—أي الذي يتم بمخالفة قوانين البناء أو خارج الأطر التخطيطية للمدن. فقد استحوذ القطاع الخاص غير الرسمي على 87% من الوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات الثماني الماضية، مدفوعًا بتخفيف القيود الحكومية مؤخرًا وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء.
ولذلك، تتزايد المخاوف من أن يؤدي تحرير الإيجارات دون حلول موازية إلى موجة نزوح اجتماعي جديدة نحو الإسكان غير الرسمي، وهي ظاهرة لم تنجح السياسات الحكومية في احتوائها رغم التوسع في بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
كما يبرز التخوف من أن يؤدي التحول في ملكية العقارات القديمة إلى دخول شركات استثمار عقاري وهيئات حكومية بهدف الاستحواذ على هذه العقارات، التي يقع الكثير منها في أحياء مميزة في القاهرة والجيزة والإسكندرية. النموذج الأبرز لهذا النمط هو شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري التي استحوذت على نحو 15 ألف متر مربع من المباني التراثية في وسط البلد، خلال العشر سنوات الأخيرة، منها 25 مبنى تاريخيًا، بهدف إعادة تطويرها وتسويقها بأسعار أعلى. كما قامت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التي تمتلك الكثير من الوحدات المؤجرة بالنظام القديم في الأحياء المميزة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بالاتفاق مع المستأجرين على الخروج من وحداتهم، واستغلالها عن طريق طرحها بالشراكة معهم مقابل نسب من الأرباح.
وقد تستغل شركات استثمارية أخرى، أو جهات حكومية، إزالة العوائق القانونية التي كانت تحمي العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل نظام الإيجار القديم، لتكرار تلك النماذج، سواء من خلال الشراء المباشر أو عبر آليات مثل نزع الملكية للمنفعة العامة. فقد شكلت عقود الإيجار الثابتة عائقًا أمام تنفيذ مشروعات تطوير عقارية استثمارية في الأحياء التاريخية والشعبية، إذ إن العقارات المأهولة بالمستأجرين المحميين بالإيجار القديم غير قابلة للتحويل أو النزع بسهولة.
يبرز هنا دور ”هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“، التي تمتلك سلطة نزع ملكية الأراضي والعقارات لصالح مشروعات التنمية، مثل سيطرتها مؤخرًا على مساحات في جزيرة الوراق. وبهذا، لا ينحصر تأثير تعديل القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل يتجاوزها ليعيد رسم خرائط ملكية واستخدام الأراضي في المناطق التاريخية داخل المدن المصرية.
الحاجة لتشريع عادل
تمثل أزمة الإيجارات القديمة في مصر إحدى القضايا المعقدة التي تتقاطع فيها حقوق الإنسان الأساسية مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. ورغم تأخر التحرك الحكومي، لا تزال الفرصة قائمة لصياغة تشريع عادل يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. ويتطلب ذلك رؤية شاملة تعيد الاعتبار لدور الدولة في تنظيم سوق العقارات، وتوجيه السياسات الإسكانية نحو العدالة الاجتماعية، من خلال فرض رقابة فعالة، وتوفير وحدات بأسعار ميسورة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تقتضي المعالجة القانونية مراجعة شاملة للتشريعات العمرانية، وضمان اتساقها مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالإخلاء القسري وضمان التعويض والبدائل السكنية. وفي السياق ذاته، ينبغي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي ومنصف، يراعي الأوضاع الاقتصادية دون الإخلال بالحق في السكن. وتبقى مسؤولية الدولة جوهرية في تأمين انتقال عادل لجميع الأطراف، سواء من خلال أدوات الدعم المباشر أو حماية المباني التاريخية من الهدم والاستحواذ، حيث إن الحل العادل لقضية الإيجارات القديمة لا يتطلب فقط أدوات تشريعية وإدارية، بل إرادة سياسية تضع الإنسان وكرامته في صلب عملية التطوير العمراني.
إبراهيم عز الدين معماري مصري وباحث عمراني، ومؤسس مشارك لـ”ديوان العمران“، وزميل سابق بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.